
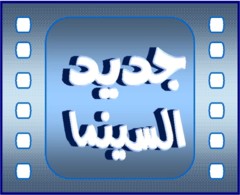
![]()
|
من المتعارف عليه عادة ان فيلم مارون بغدادي الروائي الطويل الأول "بيروت يا بيروت", اذ قُدم في عرضه الأول في العاصمة اللبنانية وتزامن عرضه (نيسان - ابريل - 1975) مع الرصاصات والقذائف الأولى, اعتبر الفيلم / النبوءة, أي العمل الفني الذي, بشكل أو بآخر, وضع لبنان في خضم الحرب الأهلية التي دامت نحو عقدين, مع انه لم يفه بكلمة عن الحرب: كان فيلماً يقول الحرب وحتميتها من خلال تصويره لمدينة أوصلتها تناقضاتها وأزماتها الى ما سيسميه الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا ميتران بفصاحة شديدة: منطق الحرب. بعد "بيروت يا بيروت" مرّت مياه كثيرة تحت أنهر كثيرة, وقامت أحداث وقعدت امبراطوريات... وحتى حرب لبنان آذنت اخيراً بالانتهاء. ولكن بعدما خلقت من رحم "بيروت يا بيروت" وجهود مارون بغدادي وبرهان علوية وجان شمعون ورفاقهم سينما لبنانية حقيقية, صادقة وفاعلة, صنعت للبنان مجداً فنياً في الوقت الذي كان وطن الأرز يغوص في وحول مآزقه. ومنذ فيلم بغدادي الأول وحتى اليوم, حقق مخرجون لبنانيون, داخل لبنان وخارجه, عشرات الأفلام التي وصل بعضها الى ذرى التكريم والبعض الآخر الى ذرى النجاح التجاري, والبعض الى كل هذه الذرى في الوقت نفسه. ولكن كل الافلام أتت لتحكي عن الحرب, تحكي الحرب, تحكي عن حرب لبنان ولبنان الحرب. وهذا الأسبوع كان موعد المتفرجين مع آخر العنقود بين هذه الافلام: فيلم "زنار النار" للمخرج بهيج حجيج الذي يقدم هنا تجربته الروائية الطويلة الأولى متأخراً نحو عقدين عن ركب رفاقه المؤسسين الذين, مع هذا, كانت بداياته معهم, منذ العودة من فرنسا (أواسط السبعينات) مروراً بتجربة الاحتجاج ضد مهرجان السينما الفرانكوفونية (بيت مري 1972) وتجربة النادي السينمائي العربي. طبعاً لن يكون من الصعب على بهيج حجيج ان يفسر سبب هذا التأخير. غير ان النتيجة التي تمخض عنها "زنار النار" ستعفيه من هذا, فهو - بعد كل شيء - فيلم يبرر تأخيره وله من الشفافية ما يكفيه لأن يفسر مبدأ انك ان تأتي متأخراً, خير من ألا تأتي ابداً. ذلك ان الملاحظة الأولية التي يخرج بها المرء من مشاهدة هذا الفيلم هو انه أتى ليلخص - أو يكاد - كل الافلام التي حققت حتى الآن عن الحرب اللبنانية, يستفيد من اخطائها, يسير على خطاها في الوقت الذي يسعى الى تجاوزها حقاً. لكن الأهم من هذا هو ذلك الانطباع الذي يتركه الفيلم عند المتفرج المعني: انطباع انه فيلم يقفل, من قلب الحرب وآلامها وعبثيتها, دائرة الحرب التي كان "بيروت يا بيروت" قد فتحها من خارج الحرب. صحيح ان هذا الكلام قد يبدو عبثياً للوهلة الأولى, طالما ان واقع الفيلمين يقول لنا ان "بيروت يا بيروت", ليس فيلماً عن الحرب اللبنانية, فيما نعرف ان "زنار النار" فيلم عنها. ولكن ماذا لو كان المنطق التناقضي هنا هو المنطق السليم؟ ماذا لو كان "زنار النار" هو أول فيلم عن الحرب اللبنانية يعلن بوضوح عدم افتتانه بالحرب, وبالتالي وقوفه تماماً خارج هذه الحرب؟ يقيناً ان ثمة من عناصر الضعف داخل الفيلم ما قد يؤدي, خطأ, الى عكس هذا الاستنتاج. ويقيناً ان المرء لكي يصل الى هذا الاستنتاج يكون عليه, أولاً, ان يعرف عن كثب رواية رشيد الضعيف "المستبد" التي اقتبس منها بهيج حجيج موضوع فيلمه, مع شيء من التصرف. وعليه بالتالي ان يدرك الفارق الجذري بين شخصية بطل الفيلم, الاستاذ الجامعي, وشخصية بطل الرواية كما صورها قلم رشيد الضعيف. ذلك ان البطل الهاذي الساخر القلق العابث الذي كان الضعيف في "المستبد" قد جعل منه واحدة من أغرب (وبالتالي أصدق) الشخصيات الروائية في الأدب اللبناني الجديد, تحول لدى بهيج حجيج الى بطل تراجيدي يدنو من مارسو بطل "غريب" كامو في الوقت الذي كان يتوجب عليه أن يكون أكثر دنواً في "ك.", "محاكمة" فرانز كافكا. لقد أحدث الفيلم في الشخصية الأساسية, إذاً, تحويلاً لم يأت في صالح العمل. ومع هذا, إذا تغاضينا عن ذلك الفارق الرئيسي بين الرواية والفيلم, سيظل أمامنا ذلك الهذيان الذي استطاعت كاميرا بهيج حجيج ان تصوره, وإن من خلال شخصيات ثانوية (حارس البناية, أستاذة الجامعة التي قامت بدورها, ببراعة نادرة, جوليا قصار...). هذا الهذيان موجود أصلاً في رواية "المستبد", بل انه يشكل عنصرها الرئيسي, لكن نقله الى الشاشة اعطاه زخماً مفاجئاً, وجعله العنصر الأساسي في ذلك الاحساس الذي أشرنا اليه: الاحساس بأننا أمام فيلم يقفل الحرب, ينهيها, لا يصورها كحنين وافتتان, بل ولا حتى كتراجيديا اجتماعية جماعية. انها هنا مجرد وباء (مثل داء زنار النار الذي يرعب جوليا قصار), مجرد عائق أمام محاولة الانسان عيش حياته, مجرد ديكور أرعن, مثل القمامة التي تملأ شوارع المدينة, مكان للقهر, حاجز يمنع التواصل ليس بين كائن وآخر, بل بين الفرد وذاته. الحرب جرثومة لا أكثر, يصح التخلص منها ونسيانها بسرعة. يصح أن ينساها المفتون بها, المستفيد منها, والذي تسببت له بكل أضرار العالم. صحيح ان الحرب وبؤسها هما ما أوقع الفاتنة المجهولة في حضن الأستاذ الجامعي, ما أعطاه - بالتواتر - مبرراً يجعل لحياته اليومية الخاوية معنى وهدفاً, ولكن الحرب نفسها هي التي أبقت المجهولة مجهولة, ما جعل اشتهاء الأستاذ الجامعي لها غير مكتمل. مثل حلم مضى ولا نزال نسأل أنفسنا عما إذا كان حلماً حقاً. بل حتى الدفتر الذي يعثر عليه الأستاذ في غرفة الحارس كدليل على أن الأمر لم يكن حلماً, وكطريق للوصول الى الفتاة... من أدرانا انه, حقاً, دفترها؟ مهما يكن من الأمر, كل هذا لا يبدو كبير الأهمية هنا. المهم هنا هو قدرة الصورة - وتحديداً في تصويرها الحرب والدمار والذل بشكل لم يتمكن أي فيلم عن الحرب اللبنانية من تصويره بهذه القوة قبل الآن - قدرة الصورة على اخراجنا, نحن المتفرجين, من الحرب, وتحويلنا حقاً الى متفرجين محايدين فاصلين انفسنا تماماً عما يحدث أمامنا على الشاشة داعين الأستاذ الجامعي, أنانا - الآخر, الى البقاء خارجها بدوره, تماماً مثلما هو خارجها حارس البناية (المتورط فيها تدريجاً وجوليا قصار وأهل الحي وأساتذة الجامعة وطلابها) بل حتى أفراد الحاجز الطائفي. ان لا أحد هنا من الحرب أو معها. الحرب شبح دخيل آت من اللامكان. يملأ الديكور ولكن في طريقه للعبور الى اللامكان. هل هذا, بعد كل شيء, شعور ذاتي أم شعور عام لدى المتفرجين؟ من الصعب تقديم إجابة حاسمة. ولكن من المؤكد أن "زنار النار" لبهيج حجيج, من شأنه أن يجعل كل فيلم يأتي بعده, عن الحرب اللبنانية, فيلماً من دون فعالية, ومن دون جدوى... فيلماً زائداً. انه الفيلم الذي, على رغم تفاوت في ادارة الممثلين, وعلى رغم بعض الثقل في الحوار, وعلى رغم مناخ أحلّ التراجيدي محل التهكمي الهذياني ما أفقد سياق الفيلم بعض دلالاته وجعل بعض مشاهده, التي كان من المفروض أن تُعامل بعبث وهذيان, غير قابلة للتصديق اذ ارتدت مسوح التراجيديا وربما الميلودراما (كل المقطع المتعلق بقريبة حارس البناية واقامتها في شقة الأستاذ), انه الفيلم الذي على رغم كل هذا, تمكن في رأينا من أن يغلق من الداخل دائرة فتحها "بيروت يا بيروت" من الخارج. وهو لو لم يفعل غير هذا, لكان في وسعنا أيضاً أن نعتبره فيلماً متميزاً, ينتمي بقوة الى تيار سينمائي لبناني ولد قبل ربع قرن ولا يزال يولد في كل مرة من جديد. حريدة الحياة في 12 ديسمبر 2003
مارون بغدادي: طارد الحلم الأميركي وانتظره الموت في عتمة الوطن ثلاثون عاماً مرت منذ وصل مارون بغدادي الى بيروت, عائداً من فرنسا, ليؤسس السينما اللبنانية الجديدة, مع برهان علوية وجان شمعون وآخرين. وعشر سنوات مرت منذ عاد مارون بغدادي مرة أخرى الى بيروت بعد غياب سنوات, ليحقق فيلماً جديداً عنه وعنها فكان الموت له في المرصاد. في مثل هذه الأيام من العام 1993 قتل مارون بغدادي في حادث يبدو لتفاهته عصياً عن التصديق. وحتى اليوم لا يزال ثمة كثر لا يصدقون ان ما حدث قد حدث على النحو الذي استقرت عليه الحكاية. ولكن هل يبدو هذا مهماً اليوم بعد كل هذه السنوات؟ في حسبة بسيطة سنجد ان السينما اللبنانية الجديدة عاشت في "عصر مارون بغدادي ورفاقه الذين صاروا الآن - وبسرعة حركة الزمن! - مخضرمين" عقدين من السنين. وما لا شك فيه أن مارون بغدادي كان طوال ذينك العقدين, الأبرز والأكثر ديناميكية و... اثارة للجدل. فهو, مثل كل الذين يسرعون بالانفصال عن جيلهم, عرف مساراً حياتياً ومهنياً, ميزه, وجعل منه ذات عام "واحداً من آمال السينما المصرية" - بحسب تعبير مجلة "تيلراما" في ذلك الحين, وكان يجعل منه واحداً من مخرجي الموجة الجديدة في هوليوود, في ظل فرانسيس فورد كوبولا, لولا افلاس شركة هذا الأخير في ذلك الحين. فالواقع ان مارون بغدادي الذي كان قصد هوليوود في ذلك الحين, انضم الى جماعة كوبولا وتدرب على يديه في فيلم "واحد من القلب" ما اتاح له الاتصال, مثلاً بالكاتب - المخرج بول شرايد, ليكتب له هذا الأخير سيناريو كان مارون يزمع تحقيقه بعد مشروعه الأخير "زوايا" الذي قتل في بيروت من دون تحقيقه. ولئن كانت حكاية مارون بغدادي مع السينما الأميركية مختصرة الى هذا الحد, فإن حكايته مع السينما الفرنسية كانت أطول وأعمق. فمارون, منذ انتهت مرحلته اللبنانية الأولى, وقصد فرنسا أوائل الثمانينات مع فيلمه الروائي الطويل الثاني "حروب صغيرة", ارتبط, انتاجاً ثم مواضيع, بالسينما الفرنسية. ارتبط بها أولاً كلبناني يسعى وراء من يمول مشاريعه في فرنسا, ثم كمخرج يهتم بالمواضيع الفرنسية, على الشاشتين الكبيرة والصغيرة. والحال أن تميزه في سينماه اللبنانية, جرّ وراءه تميزاً في السينما الفرنسية, بل حتى تميزاً لافتاً حين حقق فيلمه الوحيد للتلفزة البريطانية "بطيئاً... بطيئاً في الريح" عن قصة لباتريسيا هايسميث. يومها كان هذا الفيلم واحداً من شرائط بوليسية عدة كُلف بها مخرجون من شتى أنحاء العالم, فكان اجماع على ان شريط بغدادي كان الأفضل. ولن نبدو فعالين هنا إن نحن نقلنا عن الفرنسيين أنفسهم أن الشريط الذي حققه بغدادي نفسه للتلفزة الفرنسية عن مقتل الثائر مارا, ضمن اطار سلسلة انتجت في ذكرى الثورة الفرنسية, ان فيلم مارون بغدادي كان هنا, أيضاً, الأفضل. فالحال ان مارون بغدادي كان سينمائياً... ولد كذلك وعاش كذلك. كانت الصورة حياته وهمه وقوته اليومي. ولم يكن مبدعاً في السينما (والتلفزة) بل كان متفرجاً متميزاً أيضاً. فهل علينا أن نذكِّر بأنه ما كان يمضي يوماً من حياته من دون أن يشاهد فيه أفلاماً عدة؟ ومن دون أن يقرأ عن السينما؟ ومن دون أن يخوض النقاش أثر النقاش من حولها؟ وكل هذا يمكننا اليوم, وفي كل بساطة, أن نشاهده في أفلامه, أو ما تبقى منها. ذلك أن ثمة أعمالاً لبغدادي صارت اليوم كالأشباح: تحس وجودها, تعرف عنها كل شيء, ولكن من الصعب أن تشاهدها. والحال أن سينما مارون بغدادي لم تنتظر موته لتكون هكذا. فهو, نفسه, خلال حياته, كان - لغاية أو لأخرى - يخفي هذا الفيلم أو ذاك, يكره هذا الفيلم أو ذاك. والواقع اننا إذا شاهدنا اليوم بعض أفلام مارون بغدادي - في مرحلته الأولى - يمكننا أن نفهمه ونعذره. فهو, لحبه السينما ولأن السينما بالنسبة اليه كانت فن الكمال, كان يحب الوصول الى الكمال. طبعاً هو لم يصل اليه أبداً, لكنه وصل الى صورته عنه على الأقل... لكن لاحقاً, حين اتيحت له الظروف التقنية التي مكنته من ذلك: في فرنسا تحديداً. في لبنان منذ العامين 1973 - 1974, بدأ مارون بغدادي عمله السينمائي بعدما درس الحقوق والعلوم السياسية في لبنان, ثم السينما في فرنسا. وكان "بيروت يا بيروت" طويله الروائي الأول ثم كان "حروب صغيرة" آخر روائي طويل حققه في لبنان. الفيلمان عن الحرب, أولهما يتنبأ بها (1975) والثاني يعلن افتتان المخرج بها ورغبته, في الآن معاً, في مبارحتها. بينهما حقق شرائط قصيرة عدة, منها ما هو نضالي ومنها ما هو متهكم ومنها ما هو شاعري. وفي الأحوال كافة كان ذلك كله يعلن مجيء مخرج كبير وسينما متميزة تعطي لبنان نكهة سينمائية ما كانت له أبداً في تاريخه. بعد عرض "حروب صغيرة" في "كان", قرر مارون بغدادي البقاء في فرنسا. وهناك كان من أول أعماله فيلم "الرجل المحجب" الذي - الى تميزه الفني - جاء أشبه بتصفية حساب سياسية مع افتتان مخرجه السابق بالحرب. ومن هنا أثار من السجال ما أثار. بعده تراجعت حميّاً تصفية الحساب لديه فكان "لبنان أرض العسل والبخور" عن فصل من حكايات "أطباء بلا حدود", في موضوع عاد اليه في "خارج الحياة" - أفضل أفلامه على الاطلاق الى جانب "الرجل المحجب" - الذي أعطاه جائزة لجنة التحكيم في مهرجان "كان" - شراكة مع "أوروبا" لارس فون تراير. والحال ان "خارج الحياة" عاد عليه بشهرة كبيرة وجعله, بالنسبة الى المنتجين الفرنسيين, ورقة رابحة يمكن المراهنة عليها. ومع هذا كان عليه أن ينتظر بعض الشيء قبل أن يخوض تجربة روائية سينمائية أخيرة في فيلم "فتاة الهواء" عن حكاية واقعية فرنسية خالصة. وفي تلك الأثناء كان عملاه التلفزيونيان "مارا" و"بطيئاً بطيئاً... في الريح". وإذا كان "فتاة الهواء" تميز باقتصاد سينمائي مدهش وبلغة بدت في نهاية الأمر منتمية الى السينما الأميركية الجديدة, أكثر من انتمائها الى ثرثرة السينما الفرنسية, فإنه كان يشكل خطوته التي من المفروض أن توصله الى السينما الأميركية - حلم ماضيه الكبير, فنياً لا سياسياً -, ولكن في تلك الأثناء كانت الحرب اللبنانية هدأت, ورأى بغدادي ان عليه, بعد, أن يقوم بتصفية حساب أخيرة مع "الوطن". وهكذا ولد مشروع "زوايا" الذي أحب أن يحققه ليغلق الدائرة التي كان فتحها مع "بيروت يا بيروت" قبل أن يسافر الى هوليوود ويدير تيم روث هذه المرة, بعدما دار ميشال البرتيني وهيبوليث جيراردو وبياتريس دال وعزت العلايلي وريشار بورانجيه وجيمس فوكس وغيرهم. ولكن في لبنان, في مثل هذه الأيام بالذات, قبل عشر سنوات, كان الموت ينتظره في قفص الدرج لبناية تقطنها أمه, في عتمة الليل. وانتهت هكذا حكاية مخرج من هذا البلد ميتاً في وطنه, تثار حول موته أسئلة كثيرة, بعضها أغلق لانتفاء الأدلة... والبعض الآخر, لأن الثمن الذي دفع لاغلاقها كان مقنعاً.
عاشق الصورة: أحلم بدولة واعية تتولى مساعدة الإبداع السينمائي مارون بغدادي هذا المقال الذي كتبه مارون بغدادي في العام 1977 (ونقله كاتب هذه السطور الى العربية في حينه) تجاوز عمره ربع القرن. في ذلك الحين كان بغدادي انجز فيلمه الأول "بيروت يا بيروت" قبل عامين, وراح يعرضه ويرافق عرضه بين مكان وآخر. ووصل عامها الى باريس حيث شارك فيلمه في مهرجان للسينما العربية هناك. ولدى عودته بعد العرض, طلبنا إليه أن يكتب الينا بعض الانطباعات عن فيلمه وعن الأفلام العربية الأخرى التي شاهدها, هو الذي كان الى الاخراج, يكتب في السينما وفي العلوم الاجتماعية. وهنا نتيــجة هــذا الطـلب, ســطور وفقــرات واضــح ان معظمـها لم يفقد راهنيته حتى الآن, بعد كل تلـك السنــين, وبـعد عقد من رحيل كاتبها. (تقديم ابراهيم العريس)
1 - اذاً.. ها نحن ذا اذاً, ها نحن في باريس. ترى لماذا نسعى بإلحاح الى البحث عن اعتراف بنا وبقدرتنا, في العاصمة الفرنسية؟ ربما لأن في إمكاننا أن نقلب في باريس بعض النظم. ان أكثر من نصف الأفلام المعروضة لم يتمكن من التواجه مع جمهور عربي... هو جمهوره الأصيل. أنا لن أكشف أسباب هذا لكنني أعتقد بأن مثل هذا الوضع ليس من شأنه إلا أن يلقي الى الهامش أكثر وأكثر أولئك المبدعين.. المستلبين أصلاً. الليلة الأولى خصصت لعرض "عودة الابن الضال" ليوسف شاهين. القاعة معادية للفيلم. لقد أتوا جميعاً للتعرف على آخر انتاج لصاحب "الأرض" ولكن يبدو أن أملهم خاب. ومع هذا ربما كان "عودة الابن الضال" هو الفيلم الذي عبر فيه شاهين عن نفسه بأفضل ما يمكن. ومن الواضح ان شاهين يثير الخيبة لدى كل أولئك الذين قرروا "عنا" أن "سينما العالم الثالث" يجب أن تكون واقعية, حافلة بالبؤس وبالتبسيط إذا أمكن... أما شاهين فإنه ينحو باتجاه الخيال أحياناً, وهنا سر ابداعه. عندما يحاول مخرج مثل يوسف شاهين أن يلتقط صوراً جميلة, يقولون: انها اعلانات بيبسي كولا... والشمس, في السينما العربية, يجب "دائماً" أن تغيب بالأسود والأبيض(!), بدلاً من هذا كله كان ينبغي التساؤل عن السبب الذي يجعل أفلام يوسف شاهين لا تلقى إقبالاً جيداً في مصر. هنا تكمن المسألة الأساسية. والجواب هو أن شاهين هو الوحيد الذي وقف ويقف بعناد ضد الجهل وفساد الذوق اللذين فرضتهما أطنان من الأفلام المتخلفة. (...) 2 - بعد بدايات واعدة اليوم نلتقي بسمير فريد, الناقد المصري, ومواطنه المخرج توفيق صالح الذي يعيش في بغداد... آخر فيلم حققه صالح صار عمره الآن خمس سنوات, وبعده لم يحقق أي عمل مهم. انه يعيش الصمت, أو المنفى الذهبي لا فارق, وأفلامه معظمها ممنوع من العرض. لقد أراد صالح أن يضع نفسه نهائياً, خارج دائرة السينما التجارية... ولكن بأي ثمن؟ يحدثنا سمير فريد عن عدد لا بأس به من السينمائيين المصريين الذين لم يعد في وسعهم تصوير أفلام جديدة بعد بدايات واعدة في مجال الفيلم القصير. يحدثنا سمير فريد عن خيري بشارة الذي سبق له أن حقق ثلاثة أفلام قصيرة رائعة: "صائد الدبابات" و"يوميات طبيب في الريف" و"طائر النورس". بشارة أنهى أخيراً فيلمه الطويل الأول "أقدار دامية", لكنه يواجه الكثير من الصعوبات بسبب نزاع مع منتج الفيلم. في قاعة السينماتيك شاهدنا "عرس الزين" للكويتي خالد الصديق. خيبة كبرى. فهذه الوثيقة الاثنولوجية أضحت مبرراً لإعادة وتكرار مملين ولا مبرر لهما. ان تصوير التقاليد عبر ربطها بمحتواها الاجتماعي قد يكون مسعى مهماً اذا لم تنغلق على نفسها, مكتفية بأن تكون مجرد تصوير طقوسي. وهذا هو الأمر الأكثر تخلفاً في فيلم خالد الصديق, وهو الأمر الذي يشكل العقبة الأساسية لدى عدد من السينمائيين المغاربة, ولا سيما حين يصورون اليومي في طقوسيته ثم يعطونه بعداً قدسياً ويصلون به الى مستوى الفولكلور. ان افلام هؤلاء المخرجين موجهة أصلاً الى الغرب.. والأمر الديماغوجي في مسعاهم هذا, هو انهم يساعدون على تأبيد نظرة أبوية لدى الجمهور الغربي ازاء السينما العربية. "عمر قتلتو" لمرزاق علواش, 23 سنة. عمر يشعر بالسأم في الجزائر, وربما تشعر بالسأم ذاته معه فئة عريضة من الشبيبة الجزائرية. وعمر انسان يعي تماماً رجولته, مثله في هذا مثل كل الشرقيين. والفيلم يقول لنا هذا بشاعرية وافرة. شاعرية تنبع من تراكم أو تقاطع أو تكرار عناصر كثيرة من الحياة اليومية, واليومية الى حد بعيد. ان أهمية هذا الفيلم تكمن في أنه يقدم قطيعة مع الانتاج السينمائي الجزائري الذي غاص أكثر من اللازم في "المواضيع الثورية الكبرى". ينتمي هذا الفيلم الى تيار جديد, يريد أن يتحدث في شكل خاص عن المشكلات الجزائرية الراهنة, وذلك في لغة جديدة, قادرة على الوصول الى جمهورها من دون أية ديماغوجية. أمام هذا الفيلم, والمؤسسة الجزائرية التي تقف خلفه منطلقة من أسس سليمة, تذكرت الألم الذي يكمن في كون المرء سينمائياً لبنانياً.. معزولاً, ومعزولاً في شكل رهيب, غير قادر على توقع أي أمل من القطاع العام (الذي يفضل استثمار رساميله في أفلام مصرية هي أكثر ارباحاً للمنتجين اللبنانيين من محاولة فرض سينما لبنانية حقيقية). لقد استعدت في ذهني كل أولئك السينمائيين اللبنانيين العاطلين من العمل, وكل أولئك الذين خضعوا للقاعدة وانصرفوا لانتاج أفلام دعائية... عند ذاك "حلمت" بدولة تأخذ على عاتقها مهمة مساعدة الابداع السينمائي, آخذة في اعتبارها كل تلك التجارب التي عرفتها البلدان العربية, وحلمت بهيئة عامة للسينما تضمن للمبدع حرية التعبير الفني, وتساعده في الوصول الى مستوى ابداعي معين. 3 - كلما ابتعدوا عنه هذا المساء يعرض "بيروت يا بيروت". ترى كيف يمكن مشاهدة مثل هذا الفيلم بعد سنتين من انتاجه, بعد سنتين عاش لبنان خلالهما حرباً, غيرت مجالات الرؤية, وبدلت الكثير؟ هذا الفيلم بات ينتمي الى الماضي, والأمر يقوم, هذا المساء, في بعثه مجدداً, وفي الدفاع عنه. جاء ليحضر العرض لبنانيون كثيرون, معظمهم جاء سعياً وراء لحظة يستعيد فيها خصوصيته, ورغبة في معرفة ما تبقى له من أوهامه وتفسيراته للأمور. تولى برهان علوية تقديم "بيروت يا بيروت" معلناً انه رآه مسبقاً وأحبه كثيراً. وهو في كلمته التقديمية عن الفيلم وضعه ضمن اطار تيار جديد (يعتبر نفسه طرفاً فيه) يريد التعبير عن الواقع ومجابهته بلغة جدية. وهو تيار, قال علوية, يقف ضد تيار سينما الترفيه والتشويه. عندما أخذت الكلام, فسرت للحضور كيف أن هذا الفيلم قد أنتج في العام 1975, وانه ينضوي ضمن نطاق فترة تاريخية تمتد بين الغارة الاسرائيلية على مطار بيروت في العام 1968, وبين وفاة عبدالناصر في العام 1970. خلال عرض الفيلم لم يكن المشاهدون عدائيين. بل وبعضهم صفق لبعض المشاهد (بيروت من البحر, منطقة مقهى الحج داوود عند مغيب الشمس), وفي ما يلي خلاصة النقاش الذي دار حول الفيلم: التمثيل كان مسرحياً, وهو الأمر الذي أساء أحياناً الى المناخ المطلوب. المونتاج لم ينفع الفيلم, بل ساعد على إحداث مزيد من التفكيك فيه. الانتقادات السياسية كانت متنوعة, وأحياناً سهلة, وغالباً غير متوقعة. بعضهم تحدث عن الابهام في الفيلم. والابهام صادر عني, عنا جميعاً بالتأكيد, وعن تمزقنا خلال فترة كان لبنان يعيش فيها عشية حربه. والابهام يأتي, في شكل خاص, من الانقسام الذي لم نشأه, لكنه كان, مع هذا, واضحاً خلال الفيلم... كما هو في الواقع. انه لمن المدهش أن نستمع الى بعض اللبنانيين من الحضور, يتحدثون عن لبنان وكأنه واقع يقف خارج ذواتهم. هؤلاء كلما ابتعدوا عن لبنان, كلما اعتقدوا أكثر وأكثر انهم خرجوا منه. الى جانب الفيلم وقف عدد من النقاد والمثقفين, منهم مولود ميمون, الناقد الجزائري الذي رأى ان الفيلم يسير وفقاً لخط غير "صوري" مراكماً التوترات حتى لحظة الانفجار الأخيرة. أما الشيء الصوري, فهو ذلك الواقع السياسي الذي طبع الفيلم معطياً إياه بنيته الايديولوجية. كثيرون أحبوا موسيقى وليد غلمية, وتمثيل أحمد الزين وجوزيف أبو نصار. وكثيرون لمسوا درجة تنبؤ الفيلم بالأزمة اللبنانية, وقالوا انه يحتوي في داخله كل العناصر التي حملتها المأساة في شكلها الجنيني. الآن بت أعرف الاختيار الانتحاري الذي يمارسه الواحد منا حين يقرر صنع فيلم محدد التاريخ, يسقط فيه كثير من جوانية أفقه الدرامي. (...) 4 - دون كيشوت بعد عامين, ها نحن نعيش دائماً في التمزق نفسه, والماضي لا يزال قائماً لا يترك لنا أي فرصة للراحة. ان الماضي ثقيل ثقيل, غير انه ينبغي علينا أن ندركه في احباطاته اليومية. هذا المساء نشاهد "لا يكفي ان يكون الله مع الفقراء" وهو فيلم تسجيلي حققه برهان علوية حول المهندس المعماري المصري حسن فتحي. الفيلم مجمد الوضع وممنوع من العرض, لأن اليونسكو ومصر, الشريكين في الانتاج ليسا موافقين على محتواه.. على رغم موافقتهما المسبقة على السيناريو. خلاصة نقاش بيني وبين برهان علوية: علينا أن نفرض نفسنا عبر عمل كمي, من دون أن نبالغ في تقديم التنازلات. وهذا العمل في إمكانه, عند النهاية, أن يقلب ميزان القوى لمصلحتنا... عندها نكون خلقنا جمهورنا السينمائي الخاص. وبرهان يعمل الآن على انجاز سيناريو فيلمه الروائي الجديد "الأمير". أما أنا فأعود الى بيروت, وأكتب هذا النص على سبيل الخاتمة: الكلمة ضد الصورة. الصورة زائد الصوت تساوي الحياة. الحياة بعد أن يعاد اختراعها, ويعاد لها طابعها الدرامي, وتعاش من جديد. الكلمة التي تحدد الصورة تخلق لها ماضياً معيناً, تحولها الى ذاكرة. ولعل هذا هو السبب الذي يجعلنا نتسامح مع هذا الاحباط الأخير. تماماً مثلما يتسامح الناس مع عملية الغش في اللعب. فاللعب لا يتحمل أية قواعد محددة. والمهم في الأمر ألا يكون المرء وحده. وإلا لا يبقى أمامه الا أن يقرأ "دون كيشوت" ويعيد قراءتها. نيسان (ابريل) 1977 مارون بغدادي. |

|
مارون بغدادي طارد الحلم الأمريكي وإنتظره الموت في عتمة الوطن بقلم: إبراهيم العريس |

![]()

![]()